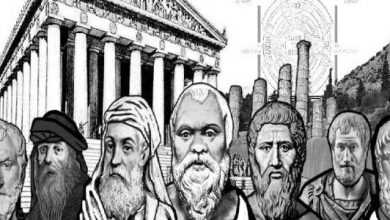تأملات فلسفية في مفهوم الحقيقة

تأملات فلسفية في مفهوم الحقيقة
بسم الله الرحمان الرحيم، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد
يقول الفيلسوف الألماني فريديريك نيتشه: “الاعتقادات الراسخة عدوة الحقيقة، فهي أخطر من الأكاذيب”، إن المقصود هنا بالاعتقادات الراسخة تلك المعتقدات المتوارثة التي لا يعلم الإنسان مصدرها ولا متى تلقاها، لكنه يجد نفسه مدافعا شرسا عنها، ومتيقنا من صحتها إلى درجة استعداد البعض للموت من أجلها، فلماذا هي أخطر من الأكاذيب، وكيف يمكن اعتبارها عدوة للحقيقة؟
هي أخطر من الأكاذيب لأن الأكاذيب يسهل اكتشاف زيفها من جهة، ولأن الكاذب يعرف أنه كاذب، أما الدغمائي المتشبث باعتقاداته فلا يقبل غيرها، ولا يستطيع التنازل عنها أو الاقتناع بغيرها، لأنه يعتقد أنها الحقيقة، فكلما شدد الإنسان قبضته على الفكرة، إلا وتكون له (في حالة خطئها) حجابا عن الحقيقة، وكلما كان لينا في التصورات، إلا وأمكنه تقبل نقيضها، أو على الأقل مناقشتها
وبهذا يكون الواثق أبعد الناس عن الحقيقة، وأكثرهم ركونا للمعتقدات الخاطئة، ويكون المسلّم بجهله وقصور فهمه أقرب الناس إلى الحقيقة، وأكثرهم تقبلا لها، وفي هذا الصدد كان يقول سقراط:” كل ما أعرفه أنني لا أعرف شيئا”، معترفا ــ بفضل حكمته ــ بجهله وبعد الحقيقة عنه.
إن الحقيقة التي ينشدها الفلاسفة هي الجوهر الثابت الذي لا يتغير بتغير الزمان والمكان، والذي يقف في مقابل الأعراض الزائلة المتغيرة والمتحولة، لذلك يمكن أن نبين اختلاف بعض المفاهيم التي نرادف بها عادة مفهوم الحقيقة عن التعريف الذي قدمناه
فعادة ما نقابل الحقيقة بالصدق، أي أن قول الصدق هو قول الحقيقة، لكن ألا يمكن أن أكون صادقا في قولي مع أنني لا أقول الحقيقة؟
طبعا يمكن ذلك، فالصدق هو أن أقول ما أعتقد أنه حقيقة، لكن ليس بالضرورة ما أعتقده هو فعلا حقيقة، ولا يمكن أن أنعت بالكذب إلا إذا أدليت بعكس ما أعتقد بأنه الحقيقة، وبناء على ذلك تكون الحقيقة غير الصدق.
فهل الحقيقة إذن هي الأفكار الواضحة اليقينية؟
إن أوضح الحقائق بالنسبة للإنسان العادي البسيط هي الحقائق الواقعية التي يراها ويلمسها ويحتك بها بواسطة حواسه، ذلك أنها معطاة بشكل مباشر لا تتطلب منه عناء البحث عنها، فهل كل ما هو واقعي هو حقيقي؟
قد تكون خصائص الأشياء أكثر ما نحن متأكدون من صحته، وأقل ما يمكن أن نختلف حوله، ويعد اللون من بين أهم الخصائص الواضحة البينة، لكن حقيقة الأشياء أنها بدون لون، وما الألوان التي نراها مصبوغة بها سوى انعكاس ألوان الطيف التي تصدر عن الأشعة على الأجسام، ذلك أن تركيبة الجسم الكيميائية تمتص بعض الألوان وتعجز عن امتصاص أخرى، فتظهر عليها تلك التي عجزت عن امتصاصها، إذن فاللون وهم
ثم إن تصور الواقع نسبي، فهو يختلف من شخص إلى آخر، ومن مكان إلى آخر، ويمكن أن نضرب هنا مثالا قدمه العالم الرياضي الكبير هنري بوانكاريه، يتمثل في الافتراض التالي: استيقظنا في الصباح وكان كل شيء في الواقع تضاعف حجمه بنسبة 1000 ضعف، هل سنشعر بأن شيئا تغير؟ طبعا لن نشعر لأن كل شيء تغير، ولأن النسبة بين الأشياء بقيت محفوظة، إذن هل يمكن أن تكون أفكارنا حول الواقع حقيقية؟ هل يمكن أن نعتقد أننا نعرف حجمنا وحجم الأشياء المحيطة بنا وسرعتها وحركتها؟ إننا لا نعرفها إلا نسبيا، من خلال زمان ومكان تواجدنا، وقدرات حواسنا
إذن فالواقعي ليس بالضرورة حقيقي، لأن الواقع كما تأكد لنا نسبي ومعرفتنا به متغيرة، لكن الحقيقة كما أسلفنا مطلقة وثابتة، فهل يمكن أن يكون المنطق وسيلة لبلوغ الحقيقة؟
يعتبر المعيار المنطقي أحد أهم المعايير التي يعتمدها الإنسان لتجنب الأخطاء، فالمنطق هو قياس عقلي يشترط الاتساق وعدم التناقض بين الأفكار، وليس بين الفكرة والواقع كما هو الشأن بالنسبة للمعيار الواقعي الذي ذكرناه، فمثلا لنأخذ القاعدة التالية
إذا كان كل ” أ ” هو ” ب ”
وكل ” ب ” هو ” ج ”
فإن كل ” ج ” هو ” أ ”
فالتوصل إلى هذه القاعدة جاء عبر قياس الفكرتين الأولى والثانية، فلنحول هذه الرموز إلى موجودات
إذا كان كل إنسان خالد
وكل خالد لا يموت
فإن الإنسان لا يموت
هذه النتيجة خاطئة واقعيا، لأنها منطلقة من فرضية خاطئة ( كل إنسان خالد) لكنها صحيحة منطقيا، لأنها تحترم القاعدة السالفة الذكر، وتخلو من التناقض
إذن فالمعيار المنطقي ليس سوى آلة تعصم الذهن عن الوقوع في التناقض، ولا يمكن بأي حال أن تبلغ هذه الآلة الحقيقة
نستطيع القول انطلاقا مما سبق أن كل المرادفات التي عادة ما نطلقها على الحقيقة من صدق وواقع ومنطق لا تعبر عن الحقيقة، فما الحقيقة إذن؟
لنعد إلى الفيلسوف الذي انطلقنا من فكرته، لنرى كيف يتصور الحقيقة، إنه يرى أن الحقائق التي نؤمن بها هي وهم، نحن من وضعه ونسينا مع مرور الزمن بأنه كذلك، طبعا سيخلص إلى هذه النتيجة الحتمية ما دامت كل المعايير المتاحة للتفكير الإنساني عاجزة عن بلوغ الحقيقة المطلقة التي لا يمكن التشكيك فيها، ف “نيتشه” يرى أن الإنسان يحب الوهم، ويخشى من الحقيقة لأنها صادمة، ولهذا يقول
لا يكفي لطالب الحقيقة أن يكون مخلصا في قصده، بل عليه أن يترصد إخلاصه ويقف موقف المشكك فيه، لأن عاشق الحقيقة إنما يحبها لا لنفسه من أجل مجاراة أهوائه، بل لذاتها ولو كان ذلك مخالفا لعقيدته
يعني هذا القول أن الإخلاص في طلب الحقيقة، الذي يصل بالإنسان إلى تصورات معينة، فيعتقد أنه بلغ الهدف، وترتاح نفسه ويكتفي بها ويقنع نفسه أنه بلغ نهاية هدفه، لا يمكن أن يوصل صاحبه إلى الحقيقة، لذلك وجب التشكيك حتى في هذا الإخلاص، لئلا تكون الحقيقة هي ما يتوافق مع الأهواء، بل يجب البحث عن الحقيقة مهما كانت صادمة، ومهما اختلفت مع المصالح الدنيئة للإنسان، يجب تقبل الحقيقة كما هي، لا كما أردنا أن تكون. حتى ولو تبين لنا أنها مخالفة لما توارثناه، أو ما يعتقد فيه العامة، وما ترسخ فينا من خلال التنشئة الاجتماعية، فكل هذه الأمور لا ينبغي أن تحول دون التشبث بالحقيقة إذا تبدت للمرء
لكن على الرغم من تصور الفلاسفة لطبيعة الحقيقة، وعلى الرغم من سعيهم الدؤوب والمتواصل من أجل توضيح خصائص الحقيقة، إلا أنهم لم يستطيعوا بلوغها، بل إنهم وصلوا بتشكيكهم في الحقائق المتوارثة إلى الإلحاد، وإنكار وجود الله، فاعتقدوا أن المتدين
إنسان جاهل غافل بعيد عن الحقيقة، فقد قال الفيلسوف “نيتشه” : لقد مات الله، ونحن الذين قتلناه
هذا منتهى ما أمكنه الوصول إليه، فهو يقصد أن أكثر الأفكار وهمية تلك المتعلقة بوجود إله قوي يتحكم في مصائر البشر، وبهذا يكون قد ترك مكمن الحقيقة خلفه واتجه نحو الوهم اعتقادا منه أنه الحقيقة. فأي علم ذاك الذي يبلغ بالإنسان الحقيقة؟
يقول شيخي سيدي محمد فوزي قدس الله سره عن هذا العلم : “العلم حقيقة أصل الخشية، والخشية مطية التجلي والشهود لعلماء المعنى”. المحجة البيضاء، ص 103
إذن فالعلم انطلاقا من هذا التعريف له علامة تنبثق عنه لتدل على توفر صاحبه عليه، وهي الخشية من الله عز وجل، وبناء على ذلك يمكن أن نستنتج أن من لا يخشى الله لا علم له، أما من ينكر وجود الله أصلا فهو أبعد الناس عن العلم، وأكثرهم جهلا بالحقيقة، فالعالم المستحق لهذه الصفة من كان علمه بالخالق أصل علمه بالمخلوق، لأن معرفة الجوهر تتضمن معرفة الأعراض، والعكس ليس صحيحا، فقد ميز سيدي الشيخ بين قسمين من العلماء: علماء بأحكام الله، وعلماء بالله. (نفس المرجع ص 106). فالعلماء بالأحكام لا يتميزون عن العلماء بالعلوم الدنيوية إلا من حيث شرف علمهم، أما منهج تحصيلهم فواحد لا اختلاف فيه، ذلك أن علم كل منهم يؤخذ عن طريق التلقي والتحصيل من المصنفات المتوارثة، وكذا الاجتهادات العقلية وفق ما هو متاح من قواعد وقياسات
أما العالم بالله فهو من “شاهد القدم، والأزل، والبقاء، والأبد” (نفس المرجع ص 107). أي من أطلعه الحق عز وجل عن أسراره واختصه بنوره، فالعلم نور لا سطور، مأخوذ من منبعه الأصلي لا عن طريق العقل ولا الحواس. وإذا كانت الأفكار قابلة لأن تتغير وتتحول، وإذا كان الإنسان دائم الشك في أفكاره ومعتقداته، فإن العارف بالله لا يمكنه أن ينكر علمه، كما لا يمكن أن تواري الظلمةُ النورَ، ذلك أن انعدام النور أصل الظلمة، وليس انعدام الظلمة هو أصل النور، وإذا كان “نيتشه” قد قال بموت الإله، فإنه قد عبر بذلك عن موت قلبه واحتجاب الحقيقة عنه، ذلك أن من يدرك حقيقة “الحي” هو ذو القلب الحي، ومن رضي لنفسه بالوهم بقي ميتا إلى حيث يحييه الله رغما عنه
سوف نختم هذه السطور من حيث بدأنا، أي بالسبل التي كنا قد أكدنا أنها لا توصل إلى الحقيقة، لمقارنتها بالسبيل الذي رسمه سيدي الشيخ لبلوغ الجوهر الذي يحلم الجميع ببلوغه، كل من موقعه، حيث يقول رضي الله عنه “اصعد لي بالنزول”، فأي صعود هذا الذي يتأتى لصاحبه بالنزول، أليس الصعود نقيضا للنزول، إذا كان كذلك، ألا يمكن القول أن في ذلك مخالفة للعقل؟
طبعا هو كذلك، لأن العقل الذي لا يوصل إلى الحقيقة وجب مخالفته، وعدم الانصياع له، فإذا كان العقل لا يقبل النقيض، ولا يؤمن إلا بما اتسق منطقيا، فإنه لن يستطيع تقبل “الظاهر” و “الباطن” معا أيضا، فإما أن يكون ظاهرا أو باطنا، إذا فالعقل والواقع وكل السبل التي من الممكن الاعتماد عليها تؤدي إلى أحد الخيارين، إما “نعم” أو “لا”، لكن العارف بالله يقف عند الخيار الثالث، فقد قال سيدي الشيخ في هذا الصدد: “حارت العقول بين نعم ولا”، فمن السهل أن يفضي بك التفكير إلى نعم، أو إلى لا، لكن من المستحيل أن يكون الجواب نعم ولا في نفس الوقت، وبهذا حث العارفون بالله، الممتلكون لمفاتيح الحقيقة على التسليم، والطاعة، الطاعة العمياء التي لا تبقي حظا للعقل لمناقشة أوامر الشيخ المربي، فلما كان ممتلكا للحقيقة، ولما كانت الحقيقة حيث يقف العقل عاجزا، فإن الطريق التي يرسمها لطالب الحقيقة قد تتخذ أشكالا مخالفة لما اعتاده الناس، فإذا كان الناس ينساقون عادة وراء أهوائهم، وإذا كانت منتهى مقاصدهم توفير المأكل والملبس والمنكح كما هو الشأن بالنسبة للحيوان، فقد حث أهل الله على مخالفة الأهواء، والسمو باللطافة التي شرف بها الله عز وجل بنو آدم، حيث يقول عز من قائل “ونفخت فيه من روحي” الحجر 29، لذلك فاحتقار النفس وتعظيم الغير تؤدي إلى تيسير انسياق لطائف الحقيقة إلى القلب
في الأخير أطلب من العلي القدير أن يغفر لي فيما كتبت ما يمكن أن أكون قد أسأت به الأدب مع شيخي لسوء فهمي، وأن يرزقني ببركته علما ينفعني، ونورا يغنيني عن التخبط في الجهل والوهم.
بقلم: الفقير الأستاذ إدريس الرباطي